يعد قيام الدولة العباسية (750 – 1258م) واحدة من أهم التحولات في التاريخ الإسلامي. حيث أسست لنظام حكم جديد قائم على الشرعية الدينية والسياسية، بعد الإطاحة بالدولة الأموية. واعتمد العباسيون في صعودهم على تحالفات قبلية ودعاية سياسية فعالة، مدعومة بمظالم تراكمت ضد الحكم الأموي.
أسباب قيام الدولة العباسية
يمثل نشأة الدولة العباسية عام 132هـ/750م واحدة من أهم التحولات السياسية في التاريخ الإسلامي. لم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تراكم مجموعة معقدة من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أتاحت للعباسيين الاستفادة من ضعف الدولة الأموية وإقامة دولتهم التي استمرت خمسة قرون.
ضعف الدولة الأموية وصراعاتها الداخلية
أدت الصراعات المتواصلة داخل الأسرة الأموية بعد وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك عام 125هـ/743م إلى إضعاف السلطة المركزية. ويذكر الطبري في تاريخه أن “الخلافة صارت كالكرة يتقاذفها بنو أمية”، مما خلق فراغًا سياسيًا استغله العباسيون بذكاء.
واتبعت الدولة الأموية سياسة تمييزية ضد الموالي (المسلمون غير العرب)، حيث فرضت عليهم الجزية رغم إسلامهم ومنعتهم من المناصب الهامة. يقول ابن الأثير في الكامل: “استخف الأمويون بالموالي فكان ذلك من أسباب تقويض ملكهم”.
وجد العباسيون قاعدة شعبية واسعة بين الموالي الذين رأوا في الدعوة العباسية فرصة للخلاص من التمييز. كما حصلوا على دعم قبائل خراسان الفارسية التي كانت تعاني من التهميش.
التنظيم السري والدعاية الفعالة للعباسيين
قامت الدعوة العباسية على هيكل تنظيمي سري دقيق، استمر قرابة ثلاثين عامًا (100-132هـ). يقول البلاذري في فتوح البلدان: “كانت دعوتهم سرًا حتى اكتملت أسنانها”.
واستخدم العباسيون شعارات ذكية مثل “الرضا من آل محمد” التي جمعت بين الشرعية الدينية والغموض السياسي. وفقًا لابن خلدون في المقدمة، “كانت دعوتهم جامعة لكل المعارضين”.
القيادة الجيدة والتنظيم العسكري
برزت شخصيات عباسية قيادية مثل إبراهيم الإمام وأبي مسلم الخراساني، الذين أداروا الدعوة ببراعة. كما بنى العباسيون جيشًا قويًا في خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني، مزج بين العناصر العربية والفارسية. ويذكر الطبري أن “أبا مسلم كان يعد العدة منذ سنوات”.
مراحل قيام الدولة العباسية
الدعوة السرية
بدأت الدعوة العباسية في أواخر العصر الأموي، وتحديدًا في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك، حيث انطلق الدعاة من الكوفة وخراسان لنشر أفكار الثورة. واعتمد العباسيون على شعارات غامضة مثل “الرضا من آل محمد” لتجنب الملاحقة الأموية، وجذبوا الأنصار من خلال التركيز على فكرة أن أحفاد العباس بن عبد المطلب هم الأحق بالخلافة من الأمويين.
كان للدعوة العباسية هيكل تنظيمي سري يشبه الخلايا، حيث انتشر الدعاة في المناطق النائية مثل خراسان، بعيدًا عن مراكز السلطة الأموية. واعتمدوا على تقنية التمويه، فتظاهروا بالتجارة أو العبادة بينما ينشرون أفكار الثورة. ومن أشهر الدعاة:
محمد بن علي العباسي: مؤسس الدعوة، الذي أرسل الدعاة إلى خراسان.
أبو مسلم الخراساني: القائد العسكري الذي حوّل الدعوة إلى حركة جماهيرية.
إبراهيم الإمام: الذي قاد الدعوة قبل أن يقبض عليه الأمويون ويُعدم.
إعلان الثورة العباسية
شهدت السنوات الأخيرة من الحكم الأموي تحولًا جذريًا في مسار الدعوة العباسية، حيث انتقلت من العمل السري إلى الثورة المسلحة العلنية. ومع اقتراب منتصف القرن الثاني الهجري، بدأت الدعوة العباسية تظهر إلى العلن بعد أن كانت تعمل في الخفاء لعقود. يعزو المؤرخون هذا التحول إلى عدة عوامل مترابطة، أهمها تزايد الضعف في البنية السياسية والعسكرية للدولة الأموية من جهة، واكتمال الاستعدادات التنظيمية للعباسيين من جهة أخرى.
ويعد أبو مسلم الخراساني الشخصية المحورية في هذه المرحلة الانتقالية. ففي سنة 129 للهجرة، الموافق سنة 747 للميلاد، قام بعقد اجتماع سري في مدينة مرو جمع فيه سبعين من كبار الدعاة العباسيين. وخرج هذا الاجتماع بقرار مصيري بإعلان الثورة علنًا.
كانت أولى خطوات إشهار الثورة رفع الرايات السوداء التي أصبحت لاحقًا شعار الدولة العباسية. ثم ألقى أبو مسلم خطبة جمعة تاريخية دعا فيها صراحة إلى البيعة للعباسيين ونزع الشرعية عن بني أمية.
شهدت خراسان المعقل الرئيسي للثورة سلسلة من الانتصارات العسكرية السريعة. وتمكنت قوات أبو مسلم من السيطرة على مرو عاصمة خراسان، ثم توالى سقوط المدن الرئيسية في المنطقة مثل طوس ونيسابور. وقد اتسمت هذه المرحلة العسكرية بتوسع سريع في قاعدة الأنصار، حيث انضم آلاف المقاتلين من العرب والموالي إلى صفوف الثوار. ومن خراسان، تحركت الجيوش العباسية نحو العراق بقيادة قحطبة بن شبيب، الذي حقق انتصارات متتالية على الحاميات الأموية.
معركة الزاب الكبرى
شكلت معركة الزاب الكبرى المنعطف الحاسم في الصراع بين العباسيين والأمويين. حيث مثلت اللحظة الفاصلة التي أطاحت بإحدى أكبر الدول الإسلامية وأقامت أخرى على أنقاضها.
وقعت المعركة على ضفاف نهر الزاب الكبير في شمال العراق. حيث كان قحطبة بن شبيب قد حقق سلسلة انتصارات مهدت الطريق للمواجهة الحاسمة في الزاب. حشد الخليفة الأموي مروان بن محمد جيشًا كبيرًا قوامه حوالي 120,000 مقاتل. بينما قاد عبد الله بن علي (عم أبي العباس السفاح) جيش العباسيين الذي يقدر بحوالي 100,000 مقاتل. اعتمد الأمويون على قواتهم النظامية المدربة، بينما اعتمد العباسيون على حماس أنصارهم وتجربتهم القتالية التي اكتسبوها في المعارك السابقة.
بدأت المعركة في 25 جمادى الآخرة 132هـ (يناير 750م) واستمرت عدة أيام. وتميزت بالعديد من التكتيكات العسكرية الذكية من الجانب العباسي، حيث استغلوا معرفتهم الجيدة بمسرح المعركة. وتذكر المصادر التاريخية أن العباسيين نجحوا في تطويق الجيش الأموي بعد عبورهم النهر ليلًا، مما أربك صفوف الأمويين.
وأسفرت المعركة عن هزيمة ساحقة للجيش الأموي، حيث قتل عدد كبير من قادتهم وجنودهم. وفر الخليفة مروان بن محمد إلى مصر حيث لقي حتفه لاحقًا. وكانت هذه الهزيمة بمثابة النهاية الفعلية للدولة الأموية في المشرق، حيث تمكن العباسيون بعدها من السيطرة على دمشق عاصمة الأمويين في نفس العام.
إعلان قيام الدولة العباسية
بعد الانتصار الحاسم في معركة الزاب، توجهت الأنظار إلى الكوفة حيث تمت مبايعة أبي العباس السفاح كأول خليفة عباسي. ففي يوم الجمعة 12 ربيع الأول 132هـ الموافق 28 نوفمبر 749م، اجتمع كبار قادة العباسيين وأنصارهم في مسجد الكوفة لإجراء مراسم البيعة الرسمية.
ارتدى أبو العباس السفاح ثيابًا سوداء وحمل سيفًا مغمدًا، رمزًا للسلطة والعدل. ثم قام بدعوة الحاضرين إلى مبايعته وفقًا للشريعة الإسلامية. فكان أول المبايعين عمه داود بن علي، ثم توالى بعده كبار القادة والعلماء.
وألقى السفاح خطبته الشهيرة التي حدد فيها ملامح الدولة الجديدة، قائلًا: “أيها الناس، إنا والله ما خرجنا طلبًا للدنيا ولا رغبة في الملك، وإنما أخرجنا أن نطلب بإخواننا المستضعفين”. وأكد في خطبته على مبدأ الشرعية الدينية لخلافته، مستندًا إلى قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال عمه العباس بن عبد المطلب. كما وعد بالعدل وإنصاف المظلومين، خاصة الموالي الذين عانوا من التمييز في العهد الأموي.
ومع قيام الدولة العباسية بدأ أبو العباس السفاح بسلسلة من الإجراءات السريعة لتثبيت أركان الدولة:
توزيع المناصب: عين أخاه أبا جعفر المنصور وليًا للعهد، وقلد عمه عبد الله بن علي قيادة الجيوش.
التخلص من المنافسين: أمر بملاحقة بقايا الأمويين، مما أدى إلى مقتل معظمهم في معركة الزاب وغيرها.
بناء العاصمة: شرع في بناء مدينة الهاشمية قرب الكوفة لتكون مقرًا للحكم.
السياسة المالية: أقر نظام العطاء وأعاد توزيع الأموال على أنصار الثورة.
المصادر:
الطبري: تاريخ الرسل والملوك.
ابن الأثير: الكامل في التاريخ.
البلاذري: فتوح البلدان.
السيوطي: تاريخ الخلفاء.
محمد سهيل طقوش: تاريخ الدولة العباسية.
































































































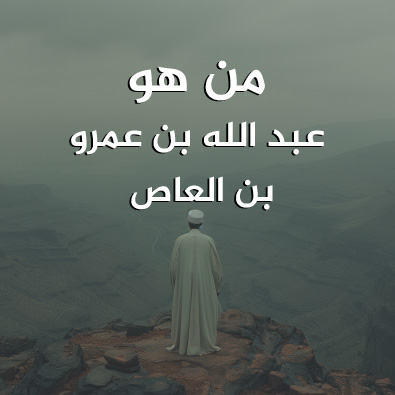




























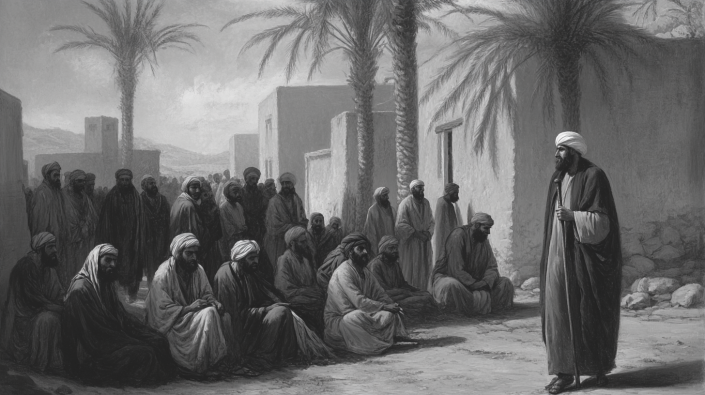













































































































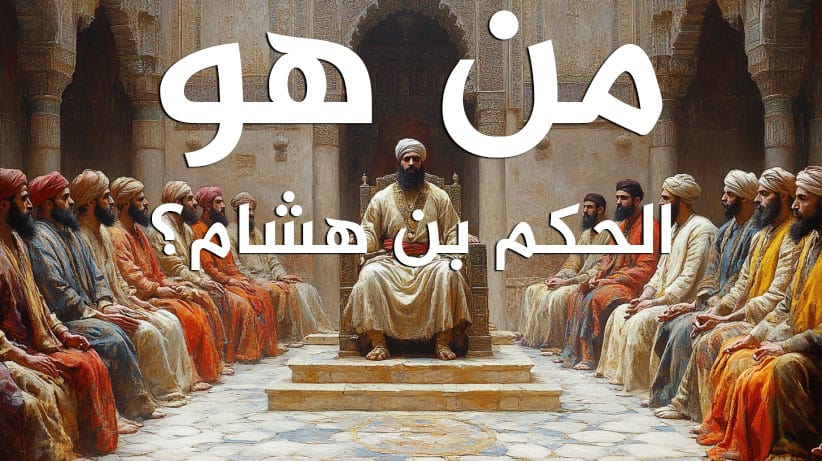






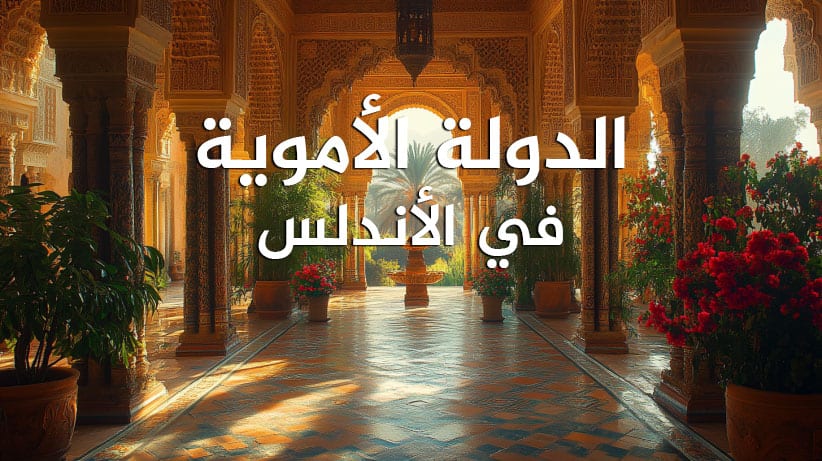

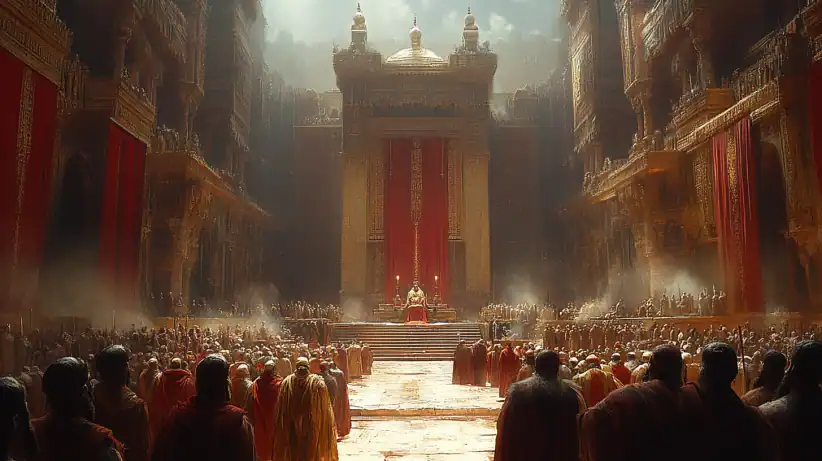

التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
اترك تعليق