كان وجود دولة المرابطين في الأندلس سببًا في إنقاذها من هجمات الممالك المسيحية الشمالية. ودولة المرابطين (1056–1147م) هي إحدى الدول الإسلامية التي حكمت المغرب والأندلس. أسسها عبد الله بن ياسين، وقادها يوسف بن تاشفين، الذي وحد المغرب والأندلس تحت حكم واحد. واعتمدت هذه الدولة على النظام العسكري الصارم والمذهب المالكي السني، مما جعلها قوة إسلامية كبرى في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي.
أصل دولة المرابطين ونشأتهم
ينتمي المرابطون إلى اتحاد قبائل صنهاجة البربرية، التي كانت تقطن مناطق الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا، خاصة في موريتانيا والمغرب الحاليين. كانت هذه القبائل تعتمد على حياة البداوة والترحال، لكنها تميزت بصلابة أبنائها في الحرب، مما ساعد لاحقًا في بناء دولة عسكرية قوية.
في منتصف القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)، ظهر عبد الله بن ياسين الجازولي، وهو داعية إسلامي متأثر بالمذهب المالكي، والذي لاحظ انتشار البدع والانحرافات الدينية بين قبائل صنهاجة. وبمساعدة أمير لمتونة يحيى بن إبراهيم الجدالي، أسس ابن ياسين حركة إصلاحية تهدف إلى تصحيح العقيدة ونشر الإسلام السني.
أنشأ ابن ياسين رباطًا (حصنًا دينيًا وعسكريًا) لتعليم أصول الدين والجهاد، ومن هنا جاءت تسمية أتباعه بـ”المرابطين” (أي المقيمين في الرباط). ومع الوقت تحول هذا الرباط إلى نواة دولة إسلامية متشددة دينيًا وعسكريًا.
بعد مقتل عبد الله بن ياسين عام 1058م، برز يوسف بن تاشفين كقائد عسكري وسياسي ماهر. قام بما يلي:
توحيد قبائل صنهاجة تحت راية واحدة.
تأسيس مدينة مراكش عام 1062م، التي أصبحت عاصمة للدولة المرابطية.
السيطرة على المغرب الأقصى والأوسط بعد هزيمة برغواطة وزناتة.
توسيع النفوذ نحو الأندلس بعد استنجاد ملوك الطوائف به لمواجهة الممالك المسيحية.
استنجاد ملوك الطوائف بالمرابطين
كانت الأندلس في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي تعاني من التفكك السياسي بعد سقوط الخلافة الأموية في قرطبة عام 1031م، حيث انقسمت إلى دويلات صغيرة عُرفت بـ”ملوك الطوائف”. وكان هؤلاء الملوك في صراع مستمر فيما بينهم، مستعينين أحيانًا بالممالك المسيحية الشمالية ضد بعضهم البعض.
كما شهدت تلك الفترة ضغطًا كبيرًا من الممالك المسيحية، ونجح ألفونسو السادس ملك قشتالة في الاستيلاء على طليطلة عام 1085م. هذا السقوط أثار الذعر في جميع أنحاء الأندلس، حيث أصبحت بقية المدن مثل، إشبيلية وغرناطة وبلنسية مهددة بالسقوط.
لم يكن لدى ملوك الطوائف القوة الكافية لمواجهة ألفونسو السادس بمفردهم. حيث كانوا منشغلين بالصراعات الداخلية، مما جعلهم غير قادرين على تشكيل جبهة موحدة ضد القشتاليين.
في ذلك الوقت، كان يوسف بن تاشفين قد وحد المغرب تحت حكمه، وكان جيش المرابطين يُعتبر من أقوى الجيوش في المنطقة. وقد عُرف عن المرابطين انضباطهم العسكري وتشددهم الديني، مما جعلهم خيارًا منطقيًا لمواجهة التهديد المسيحي.
وقام المعتمد بن عباد، حاكم إشبيلية، بدور رئيسي في استدعاء المرابطين. وفقًا للمؤرخ ابن عذاري المراكشي في كتابه “البيان المغرب”، فإن المعتمد بن عباد قد قال مقولته الشهيرة عندما نصحه مستشاروه بعدم الاستعانة بالمرابطين: “رعي الجمال خير من رعي الخنازير”، في إشارة إلى أنه يفضل حكم المرابطين المسلمين على سيطرة النصارى القشتاليين.
وبعد مشاورات بين ملوك الطوائف، تم إرسال وفد إلى يوسف بن تاشفين يطلب منه العبور إلى الأندلس لمواجهة ألفونسو السادس. وافق ابن تاشفين، ولكن بشرط أن يتم توحيد الصفوف تحت قيادته، وأن يتخلى ملوك الطوائف عن بعض سلطاتهم لصالح دولة المرابطين.
عبور المرابطين إلى الأندلس
بدأت الاستعدادات للعبور بعد وصول رسائل الاستغاثة من ملوك الأندلس. حيث قام يوسف بن تاشفين بحشد جيش كبير من قبائل صنهاجة البربرية. وقد حرص على تجهيز هذا الجيش بأفضل العتاد والخيول، مع التركيز على الانضباط العسكري الصارم الذي اشتهر به المرابطون.
اختار يوسف بن تاشفين مضيق جبل طارق كأفضل موقع للعبور، حيث كانت هذه المنطقة تحت سيطرة المسلمين وتتمتع بموقع استراتيجي. وتم تنظيم عملية العبور بدقة عسكرية فائقة، حيث عبرت القوات على دفعات منتظمة. وقد استغرقت عملية العبور عدة أيام، حيث نقلت خلالها المؤن والأسلحة والخيول.
بعد اكتمال العبور، اتجه جيش المرابطين نحو الشمال حيث كانت تتمركز قوات ألفونسو السادس. وقام يوسف بن تاشفين بتنسيق الجهود مع حلفائه من ملوك الطوائف، رغم ما كان يعتري هذه التحالفات من هشاشة بسبب الخلافات القديمة بينهم. وشكلت مدينة الجزيرة الخضراء قاعدة انطلاق رئيسية للعمليات العسكرية للمرابطين في الأندلس.
وتميزت تحركات الجيش بالسرعة والحسم، حيث تمكن من تحقيق انتصارات سريعة مهدت الطريق للمواجهة الحاسمة في الزلاقة. واعتمد المرابطون في تكتيكاتهم العسكرية على عنصر المفاجأة والهجمات الخاطفة، مستفيدين من مهاراتهم في القتال الصحراوي وخبرتهم في حرب العصابات.
معركة الزلاقة
في 12 رجب 479هـ الموافق 23 أكتوبر 1086م، اندلعت معركة الزلاقة على بعد نحو 7 كيلومترات شمال شرق بطليوس. حيث التقى جيش دولة المرابطين في الأندلس بقيادة يوسف بن تاشفين مع جيش قشتالة بقيادة ألفونسو السادس. وتعتبر هذه المعركة من أهم المواجهات العسكرية في تاريخ الأندلس، إذ مثلت نقطة تحول في مواجهة الزحف المسيحي جنوبًا.
قسم يوسف بن تاشفين جيشه إلى ثلاث فرق: المقدمة بقيادة المعتمد بن عباد، والميمنة والميسرة بقيادة قادة مرابطين، بينما احتفظ هو بالفرقة الاحتياطية. واعتمد المرابطون على تكتيك الكر والفر الذي أتقنوه في حروب الصحراء، بينما اعتمد القشتاليون على هجمات الفرسان الثقيلة.
وشهدت المعركة تحولًا حاسمًا عندما قام يوسف بن تاشفين بإدخال قواته الاحتياطية في الوقت المناسب، مما قلب موازين القوة لصالح المسلمين. وتكبد جيش ألفونسو السادس خسائر فادحة، وفر ملك قشتالة من أرض المعركة بعد أن أصيب بجروح، تاركًا وراءه معدات كثيرة وأسرى كثيرين.
وحقق المسلمون انتصارًا ساحقًا أوقف الزحف المسيحي مؤقتًا. إلا أن يوسف بن تاشفين لم يستثمر هذا النصر لاستعادة طليطلة، بل عاد إلى المغرب بعد أن ترك حاميات عسكرية في بعض المدن الأندلسية. وأدت المعركة إلى تعزيز مكانة المرابطين في الأندلس، وفتحت الطريق أمام سيطرتهم الكاملة على المنطقة في السنوات اللاحقة.
سيطرة المرابطين على الأندلس
بعد الانتصار الحاسم في معركة الزلاقة عام 1086م، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الأندلس تحت حكم المرابطين. لم يكتفِ يوسف بن تاشفين بالعودة إلى المغرب بعد المعركة، بل أدرك أن الأندلس تحتاج إلى حكم مركزي قوي لحمايتها من التهديدات المسيحية المستمرة. وهكذا بدأت عملية متدرجة لضم الأندلس إلى الدولة المرابطية.
قام يوسف بن تاشفين بسياسة حكيمة في تعامله مع ملوك الطوائف بعد الزلاقة. في البداية، ترك بعض الحكام المحليين في مناصبهم لكن تحت سيطرته المباشرة، حيث عين ولاة مرابطين لمراقبة شؤون الحكم والإدارة. ثم بدأ تدريجيًا بإزالة حكام الطوائف واحدًا تلو الآخر، خاصة أولئك الذين أظهروا عدم ولاء أو قدرة على حماية أراضيهم. وكانت غرناطة ومالقة من أوائل الممالك التي سقطت تحت السيطرة المرابطية الكاملة عام 1090م.
واجه المرابطون تحديات كبيرة في حكم الأندلس بسبب الاختلافات الثقافية بين البربر المرابطين والأندلسيين. وحاولوا فرض المذهب المالكي بقوة، مما أثار استياء بعض المثقفين والأدباء الأندلسيين الذين اعتادوا على جو من الحرية الفكرية. كما واجهوا مقاومة من بعض السكان الذين رأوا فيهم غزاةً أجانب، بالرغم من أنهم مسلمون.
من الناحية العسكرية، عزز المرابطون وجودهم في الأندلس ببناء القلاع والحصون على طول الحدود مع الممالك المسيحية. وقاموا بتنظيم الجيش بشكل أفضل، ودمجوا العناصر الأندلسية مع القوات المرابطية. كما اهتموا بتحصين المدن الكبرى مثل إشبيلية وقرطبة، وجعلوها مراكز للدفاع عن الأندلس.
لم تكن سيطرة المرابطين على الأندلس عملية سلمية بالكامل. بل واجهوا عدة ثورات محلية، خاصة في فترات غياب جيوشهم الرئيسية في المغرب. كما استمر التهديد المسيحي من الشمال، حيث حاول ألفونسو السادس استعادة زخمه العسكري بعد هزيمة الزلاقة. لكن بشكل عام، نجح المرابطون في الحفاظ على وحدة الأندلس لمدة نصف قرن تقريبًا.
انتهاء عصر دولة المرابطين في الأندلس
شهدت دولة المرابطين في الأندلس تراجعًا سريعًا خلال النصف الأول من القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي). حيث تعرضت لضغوط متزامنة من الخارج والداخل. من الشمال، استأنفت الممالك المسيحية زحفها العسكري بقيادة ألفونسو المحارب الذي استولى على سرقسطة عام 512هـ/1118م.
وفي الجنوب، ظهرت حركة الموحدين بقيادة المهدي بن تومرت التي بدأت تهدد نفوذ المرابطين في المغرب. كما أن سياسة التشدد الديني التي اتبعها المرابطون، وخاصة في عهد علي بن يوسف بن تاشفين، أدت إلى تنامي السخط الشعبي بين الأندلسيين.
وسقط آخر معاقل المرابطين في الأندلس عام 541هـ/1147م عندما استولى الموحدون على إشبيلية. وبذلك أنهوا قرابة ستين عامًا من حكم المرابطين.
المصادر:
ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب.
ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر.
الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار.
حسين مؤنس: تاريخ المغرب والأندلس.
































































































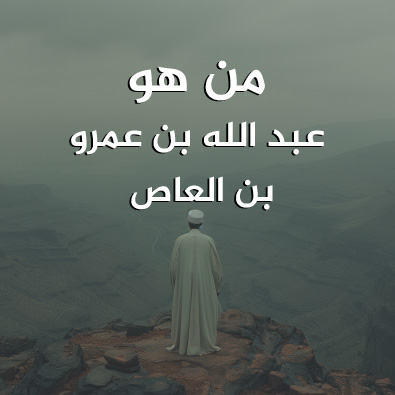




























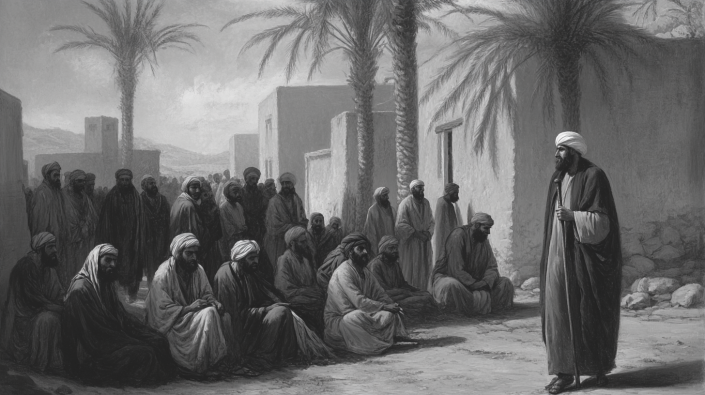













































































































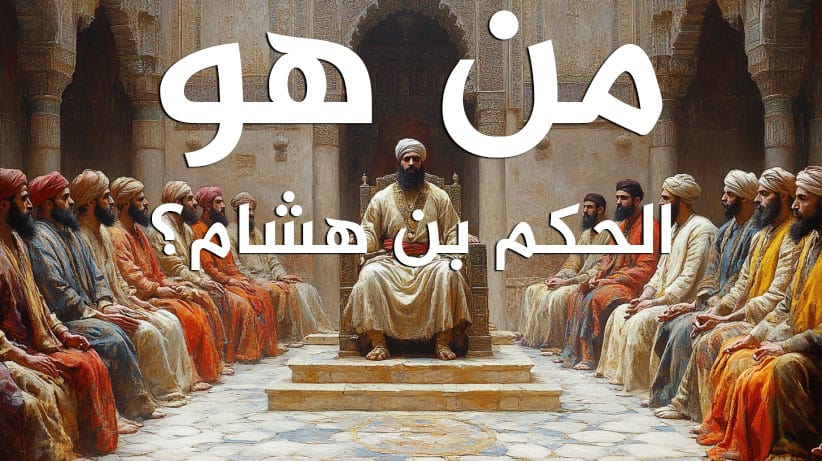






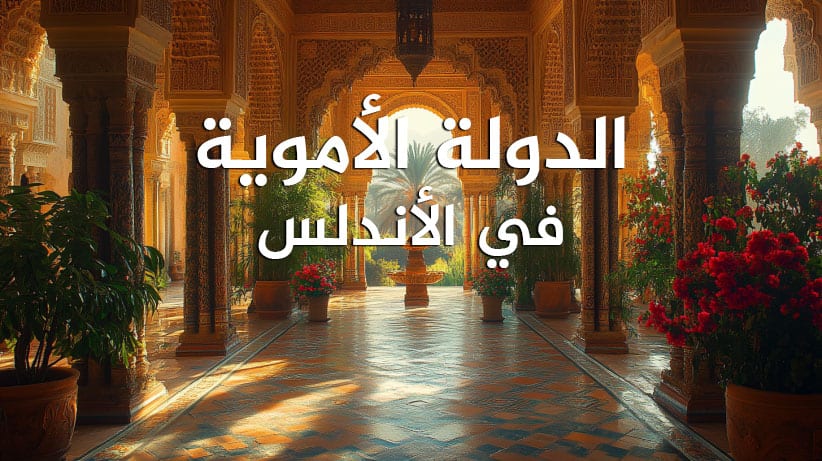

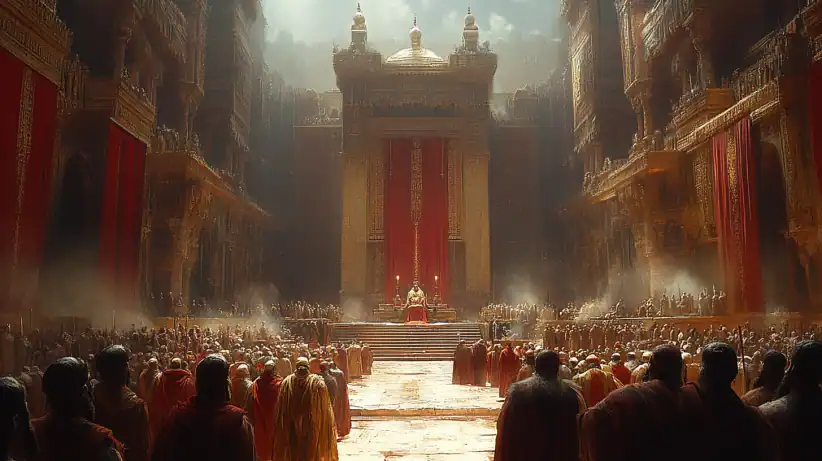
التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
اترك تعليق