امتد حكم الدولة العباسية من عام 132هـ/750م حتى سقوط بغداد عام 656هـ/1258م. ثم استمر بشكل رمزي في القاهرة حتى عام 923هـ/1517م. خلال هذه القرون، كان عدد خلفاء الدولة العباسية 54 خليفة. يمكن تقسيمهم إلى ثلاث فترات رئيسية:
العصر العباسي الأول (العصر الذهبي): 132-247هـ.
العصر العباسي الثاني (عصر النفوذ التركي): 247-334هـ.
والعصر العباسي الثالث (عصر النفوذ البويهي والسلجوقي): 334-656هـ.
وأخيرًا، العصر العباسي الرابع ( خلافة القاهرة تحت الحكم المملوكي): 659 هـ – 922 هـ.
عدد خلفاء الدولة العباسية خلال العصر العباسي الأول ( العصر الذهبي)
شهد العصر العباسي الأول حكم عشرة خلفاء أسسوا لدولة إسلامية قوية ومزدهرة. تميزت هذه الفترة بالاستقرار السياسي والازدهار الحضاري، حيث وصلت الدولة العباسية إلى ذروة قوتها وتوسعها الجغرافي.
أبو العباس السفاح (132-136هـ/750-754م)
يعد أبو العباس عبد الله بن محمد المؤسس الفعلي للدولة العباسية. تولى الخلافة بعد انتصاره الحاسم على الأمويين في معركة الزاب الكبرى عام 132هـ. اشتهر بلقب “السفاح” بسبب حملاته الدموية ضد بقايا الأمويين. وأسس أول عاصمة للعباسيين في الهاشمية بالكوفة، ووضع الأساس التنظيمي للدولة الجديدة من خلال إنشاء نظام الوزارة والحجابة. توفي بالجدري في الأنبار عام 136هـ بعد أربع سنوات فقط من حكمه، تاركًا الدولة الناشئة لأخيه أبي جعفر المنصور.
أبو جعفر المنصور (136-158هـ/754-775م)
يعتبر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. واجه في بداية حكمه تمرد عمه عبد الله بن علي، ثم تخلص من أبي مسلم الخراساني عام 137هـ. واشتهر المنصور ببناء مدينة بغداد عام 145هـ، والتي أصبحت عاصمة للخلافة ومركزًا للحضارة الإسلامية. كما طور نظام الدواوين الإدارية وخاصة ديوان الخراج والبريد. وتميز عهده بالحزم والصرامة في إدارة الدولة، كما نظم ولاية العهد لابنه المهدي. وتوفي أثناء أداء فريضة الحج عام 158هـ.
محمد المهدي (158-169هـ/775-785م)
حقق عهد المهدي ازدهارًا اقتصاديًا كبيرًا للدولة العباسية. اهتم بالعمران فبنى المساجد والقصور، وأنشأ دارًا لصناعة السفن في البصرة لتطوير الأسطول البحري. واجه ظاهرة الزندقة والمانوية، وعمل على نشر المذهب السني. تميز عهده بالتسامح الديني والاهتمام بالعلماء. وتوفي المهدي بشكل مفاجئ أثناء رحلة صيد عام 169هـ، مما أثار شكوكًا حول ظروف وفاته.
موسى الهادي (169-170هـ/785-786م)
تولى الهادي الخلافة بعد وفاة أبيه المهدي، لكن فترة حكمه لم تستمر سوى أربعة عشر شهرًا. واجه في بداية حكمه تمرد الحسين بن علي في الحجاز، كما نشب خلاف بينه وبين أخيه هارون حول ولاية العهد. حاول الهادي إصلاح النظام المالي عبر تقليل النفقات والحد من نفوذ الموالي الفرس في الدولة. وتوفي في ظروف غامضة عام 170هـ، حيث تشير بعض المصادر إلى احتمال تسميمه.
هارون الرشيد (170-193هـ/786-809م)
يعد عهد هارون الرشيد العصر الذهبي للخلافة العباسية. بلغت الدولة في عهده أقصى اتساعها الجغرافي وقمة ازدهارها الحضاري. أسس “بيت الحكمة” الذي أصبح مركزًا للترجمة والعلوم. وقاد عدة حملات عسكرية ناجحة ضد البيزنطيين. عُرف عهده برعاية العلماء والأدباء مثل الكسائي والفراهيدي. كما نظم ولاية العهد بين ولديه الأمين والمأمون، مما أدى لاحقًا إلى صراع بينهما. وتوفي الرشيد أثناء حملة عسكرية في طوس عام 193هـ.
محمد الأمين (193-198هـ/809-813م)
تولى الأمين الخلافة بعد وفاة أبيه الرشيد، لكن حكمه شهد بداية الانحدار للدولة العباسية. اندلعت حرب أهلية بينه وبين أخيه المأمون بسبب النزاع على ولاية العهد. واتسم عهده بالترف والبذخ، كما أبعَد العنصر الفارسي عن مراكز النفوذ. حوصرت بغداد في عهده وسقطت عام 198هـ، حيث قُتل الأمين على يد قائد جيش المأمون طاهر بن الحسين.
عبد الله المأمون (198-218هـ/813-833م)
يعتبر المأمون من أكثر خلفاء العصر العباسي الأول ثقافة وعلمًا. نقل العاصمة مؤقتًا إلى مرو قبل أن يعيدها إلى بغداد. اشتهر عهده بذروة حركة الترجمة والنشاط العلمي، حيث أنشأ مراصد فلكية وشجع الدراسات الفلسفية. أثارت “محنة خلق القرآن” التي فرضها على العلماء جدلاً كبيرًا. وعيّن علي الرضا العلوي وليًا للعهد في محاولة للمصالحة مع العلويين. توفي المأمون أثناء حملة عسكرية في البيزنطيين عام 218هـ.
محمد المعتصم (218-227هـ/833-842م)
أسس المعتصم نظامًا عسكريًا جديدًا اعتمد على العنصر التركي. مما أدى إلى تأسيس مدينة سامراء عام 221هـ لتكون معسكراً لجنده الأتراك. قضى على ثورة بابك الخرمي الخطيرة التي استمرت عشرين عامًا.و قاد حملة عسكرية ناجحة ضد البيزنطيين وصلت إلى عمورية. تميز عهده بقوة الجيش وزيادة النفوذ التركي في الدولة. وتوفي المعتصم عام 227هـ بعد تسع سنوات من الحكم.
هارون الواثق (227-232هـ/842-847م)
حافظ الواثق على سياسات أبيه المعتصم في الاعتماد على الأتراك. اهتم بالعلوم العقلية والفلسفية، وعُرف بعقد المناظرات بين العلماء. كما واجه في عهده بعض الثورات الداخلية التي قمعها بمساعدة قادته الأتراك. وتميز عصره بنشاط الحركة العلمية وخاصة في مجال الفلسفة والكلام. توفي الواثق عام 232هـ بشكل مفاجئ.
جعفر المتوكل (232-247هـ/847-861م)
شهد عهد المتوكل تحولًا كبيرًا في السياسة الدينية للدولة. حيث قضى على سيطرة المعتزلة وألغى محنة خلق القرآن. وأعاد الاعتبار للمذهب السني وعاقب المعتزلة. كما اشتهر عهده بالإنجازات العمرانية الكبيرة مثل بناء المسجد الجامع في سامراء وقصر الجوسق الخاقاني. انتهى حكمه بشكل مأساوي عندما اغتاله القادة الأتراك عام 247هـ. وبذلك يكون انتهى العصر العباسي الأول.
عدد خلفاء الدولة العباسية في العصر العباسي الثاني: (247-334هـ/861-945م)
شهد العصر العباسي الثاني تحولًا جذريًا في طبيعة الخلافة العباسية. حيث أصبح الخلفاء تحت سيطرة القادة الأتراك الذين تحكموا في تعيين وعزل الخلفاء وفقًا لمصالحهم. امتدت هذه الفترة الحرجة من عام 247هـ حتى 334هـ، وتقلد خلالها الخلافة أربعة عشر خليفة.
بدأت هذه المرحلة بمقتل المتوكل على الله عام 247هـ على يد حراسه الأتراك. وهو الحدث الذي مثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ الخلافة. تولى المنتصر بالله الخلافة بعد أبيه، لكن فترة حكمه لم تستمر سوى أشهر قليلة قبل أن يموت في ظروف غامضة، مما أثار الشكوك حول تورط الأتراك في وفاته.
ثم شهد عهد المستعين بالله (248-252هـ) تصاعد النفوذ التركي بشكل واضح. حيث أصبح القادة الأتراك يتحكمون فعليًا في مقدرات الدولة. بعده حاول الخليفة المعتز بالله (252-255هـ) التخلص من هيمنة الأتراك، لكن محاولاته باءت بالفشل وأجبر على التنازل عن الخلافة ثم قُتل بعد ذلك.
أما عهد المعتمد على الله (256-279هـ) فتميز بأنه الأطول في هذه الفترة، حيث استمر 23 عاماً. وشهدت هذه الفترة ثورة الزنج الخطيرة (255-270هـ) التي استنزفت موارد الدولة، كما ظهرت حركة القرامطة التي شكلت تهديدًا وجوديًا للخلافة.
بلغ ضعف الخلافة ذروته في عهد المقتدر بالله (295-320هـ) الذي تولى الخلافة وهو في الثالثة عشرة من عمره، واستمر حكمه 25 عامًا كانت فيها السلطة الفعلية بيد الحاشية والوزراء. وانتهى حكمه بمقتله في انقلاب عسكري عام 320هـ.
شهدت نهاية هذه الفترة محاولات يائسة من بعض الخلفاء مثل الراضي بالله (322-329هـ) لاستعادة بعض النفوذ، لكنها باءت جميعها بالفشل. انتهى العصر العباسي الثاني بسيطرة البويهيين على بغداد عام 334هـ، حيث أصبح الخليفة مجرد رمز بلا سلطة فعلية.
عدد خلفاء الدولة العباسية في العصر العباسي الثالث: عصر النفوذ البويهي
شهد العصر البويهي تحولاً جذريًا في نظام الخلافة العباسية، حيث أصبح الخلفاء تحت سيطرة الأسرة البويهية الشيعية التي حكمت العراق وإيران. خلال هذه الفترة التي استمرت 113 عامًا، تعاقب على منصب الخلافة أحد عشر خليفة، كانوا في الغالب مجرد رموز شكلية بلا سلطة فعلية.
بدأت هذه المرحلة بدخول معز الدولة البويهي بغداد عام 334هـ/945م. حيث فرض سيطرته على الخليفة المستكفي بالله الذي خلعه بعد فترة قصيرة. تميزت العلاقة بين البويهيين والخلفاء بالتوتر أحيانًا والتعاون أحيانًا أخرى، حيث كان البويهيون بحاجة إلى شرعية الخلافة السنية بينما كان الخلفاء بحاجة إلى حمايتهم.
برز في هذه الفترة دور الخليفة القادر بالله (381-422هـ) الذي حاول إحياء هيبة الخلافة رغم القيود البويهية. أصدر “الاعتقاد القادري” الذي حدد المذهب السني الرسمي للدولة، كما عمل على تعزيز مكانة الخلافة الدينية في مواجهة التحديات الشيعية والفكرية.
وأخيرًا، شهد عهد القائم بأمر الله (422-467هـ) أحد أهم الأحداث في هذه الفترة، وهو دخول طغرل بك السلجوقي بغداد عام 447هـ/1055م، مما أنهى السيطرة البويهية وفتح مرحلة جديدة في تاريخ الخلافة. حاول الخليفة في هذه الفترة الحفاظ على بعض الاستقلالية في ظل التنافس بين البويهيين والسلاجقة.
وتميز العصر البويهي بضعف السلطة المركزية وازدياد نفوذ الوزراء والقادة العسكريين. كما شهدت هذه الفترة تطور النظام الإداري وازدهار الحركة العلمية رغم الاضطرابات السياسية. حيث ظلت بغداد مركزًا مهمًا للعلم والثقافة في العالم الإسلامي.
عدد خلفاء الدولة العباسية خلال عصر سيطرة السلاجقة
خلال هذه الفترة التي استمرت قرابة القرن ونصف القرن، تعاقب على منصب الخلافة ثمانية خلفاء. وبدأت هذه المرحلة بدخول طغرل بك السلجوقي بغداد عام 447هـ/1055م، حيث قام بإنهاء سيطرة البويهيين الشيعيين. اعترف الخليفة القائم بأمر الله (422-467هـ) بسلطة السلاجقة، مع الاحتفاظ بالسيادة الروحية للخلافة. هذه العلاقة الجديدة أعادت بعض الهيبة للخلافة العباسية بعد فترة ضعف طويلة.
بلغت العلاقة بين الخلافة والسلاجقة ذروتها في عهد الخليفة المقتدي بأمر الله، الذي تزامن حكمه مع أوج قوة الدولة السلجوقية تحت حكم ملكشاه والوزير نظام الملك. وشهدت هذه الفترة ازدهارًا علميًا وعمرانيًا، حيث تم بناء المدارس النظامية التي جمعت بين دعم المذهب السني والنشاط العلمي.
تميز عهد الخليفة المستظهر بالله (487-512هـ) بظهور بوادر ضعف الدولة السلجوقية بعد وفاة ملكشاه. حيث حاول الخليفة استعادة بعض السلطات السياسية، لكنه واجه تحديات داخلية وخارجية. بما في ذلك بداية الحروب الصليبية التي شهدت سقوط القدس عام 492هـ/1099م.
كما شهدت نهاية هذه الفترة صراعات داخلية بين السلاجقة أنفسهم، مما أضعف سيطرتهم على بغداد. واستغل الخليفة الناصر لدين الله (575-622هـ) هذه الظروف لتعزيز مكانة الخلافة، حيث بدأ يلعب دورًا سياسيًا أكثر فعالية في السنوات الأخيرة من العصر السلجوقي.
عدد خلفاء الدولة العباسية في القاهرة: رمزية بلا سلطة
بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد على يد المغول سنة 656هـ/1258م، شهد العالم الإسلامي فراغًا سياسيًا ودينيًا خطيرًا. ثم قام السلطان المملوكي الظاهر بيبرس بإحياء الخلافة العباسية بشكل رمزي في القاهرة سنة 659هـ/1261م. حيث بايع أحمد المستنصر بالله الثاني كخليفة، وهو من نسل الخلفاء العباسيين الذين نجوا من المذبحة المغولية.
تعاقب على منصب الخلافة في القاهرة خلال الفترة المملوكية ثمانية عشر خليفة، كان دورهم يقتصر على منح الشرعية الدينية لحكم المماليك. الخليفة الأول في القاهرة، المستنصر بالله الثاني، قاد محاولة فاشلة لاستعادة بغداد سنة 660هـ، مما أكد الطبيعة الرمزية للخلافة الجديدة.
تميز عهد الخليفة الحاكم بأمر الله الأول (661-701هـ) بأطول فترة حكم في القاهرة، حيث استمر أربعين عامًا. في عهده، أصبحت مراسم البيعة للخليفة تقليدًا ثابتًا يعزز شرعية السلاطين المماليك. وكان الخلفاء يشاركون في المناسبات الرسمية ويمنحون الألقاب، لكن دون أي سلطة سياسية فعلية.
شهد القرن التاسع الهجري، تدهورًا في مكانة الخلافة حتى في شكلها الرمزي. حيث عزل الخليفة المتوكل على الله الأول (785-808هـ) عدة مرات، مما يعكس تزايد تدخل المماليك في شؤون الخلافة. مع ذلك، حافظ الخلفاء على بعض الهيبة الدينية، خاصة في العلاقات مع الدول الإسلامية الأخرى.
أما آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة فكان المتوكل على الله الثالث، الذي تولى الخلافة سنة 914هـ/1508م. وبعد هزيمة المماليك أمام العثمانيين في مرج دابق 922هـ/1516م والريدانية 923هـ/1517م، نُقل الخليفة إلى إسطنبول حيث تنازل عن الخلافة للسلطان سليم الأول، رغم انكار بعض المؤرخين لهذه الحادثة. وبذلك انتهى فصل الخلافة العباسية الذي استمر 524 عامًا في بغداد والقاهرة.
المصادر:
ابن الأثير: الكامل في التاريخ.
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة.
المقريزي: السلوك لمعرفة دول المماليك.
ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور.
حسين مؤنس: تاريخ الخلافة العباسية.
ابن إياس: بدائع الزهور.
ابن خلدون: المقدمة.
السيوطي: تاريخ الخلفاء.
الذهبي: سير أعلام النبلاء
































































































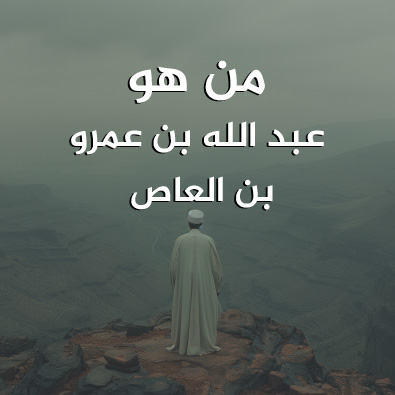




























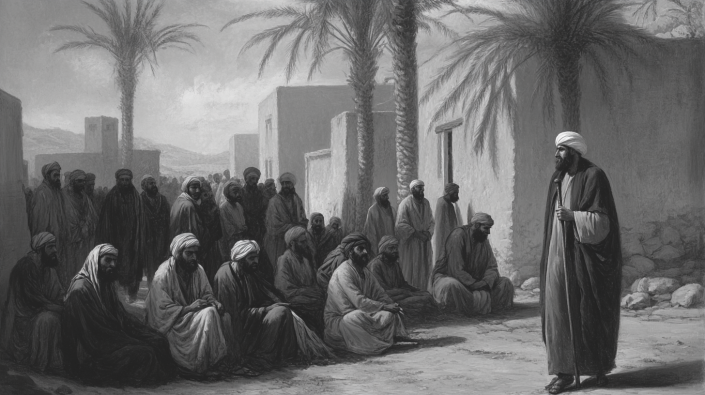













































































































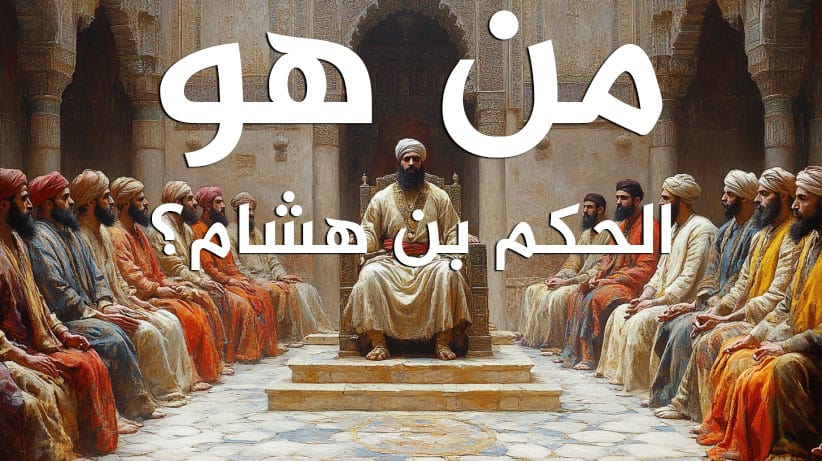






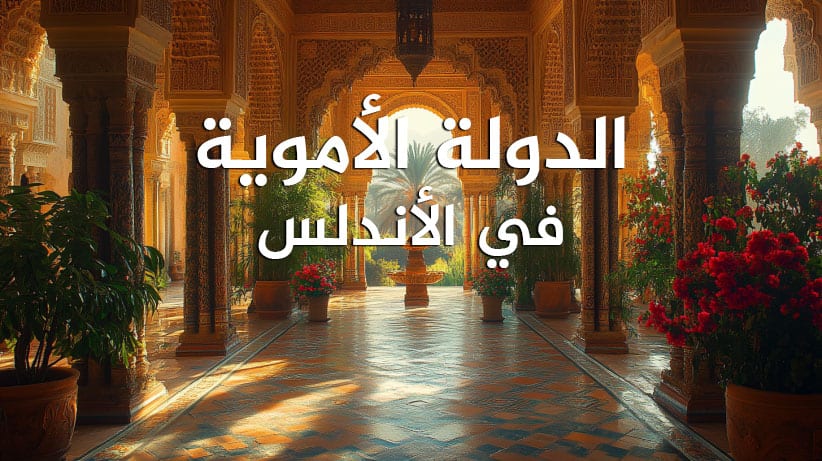

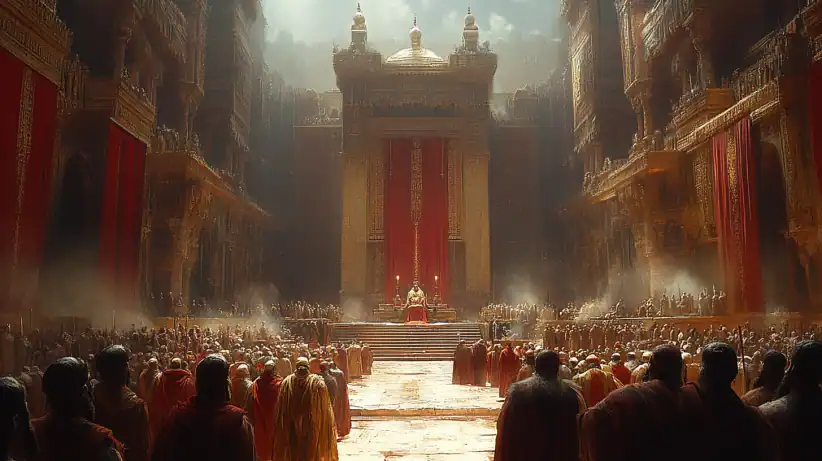

التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
اترك تعليق