مملكة غرناطة (635–897هـ / 1238–1492م) كانت آخر دولة إسلامية في شبه الجزيرة الأيبيرية، وحافظت على استقلالها لأكثر من 250 عامًا بعد سقوط قرطبة وإشبيلية. تأسست على يد محمد بن يوسف بن نصر الأحمر (المعروف بابن الأحمر)، الذي حوّل هذه المدينة الجبلية إلى قلعة منيعة ومركز حضاري لامع، رغم الحصار المسيحي المتواصل. وجمعت غرناطة بين القوة العسكرية والازدهار الثقافي، لتصبح نموذجًا للصمود والفنون في آنٍ واحد.
سقوط دولة الموحدين في الأندلس وتأسيس مملكة غرناطة
شهدت الأندلس في النصف الأول من القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) تحولًا جذريًا في موازين القوة السياسية. حيث بدأت دولة الموحدين تدخل في مرحلة من الضعف والانحدار، خاصة بعد هزيمتهم الساحقة في معركة العقاب سنة 609هـ، أمام قوات الممالك المسيحية. وكانت هذه المعركة نقطة التحول الحاسمة التي فتحت الباب أمام سقوط المدن الأندلسية الكبرى واحدة تلو الأخرى.
في أعقاب هذه الهزيمة، بدأت سلطة الموحدين في الأندلس بالانهيار بشكل متسارع. ففي غضون ثلاثين عامًا فقط، سقطت المدن الرئيسية مثل قرطبة وإشبيلية في أيدي القوات المسيحية. وقد ترافق هذا السقوط مع تفكك الوحدة السياسية للمنطقة، حيث ظهرت دويلات صغيرة تحاول الصمود في وجه الزحف المسيحي.
في هذا المناخ المضطرب، برز محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر كأبرز القادة المسلمين في الجنوب الأندلسي. استطاع هذا القائد الذكي أن يؤسس مملكة غرناطة سنة 635هـ/1238م، بعد أن حصل على اعتراف من فرديناند الثالث ملك قشتالة بشرط دفع الجزية. اختار ابن الأحمر غرناطة عاصمة لملكه نظرًا لموقعها الاستراتيجي المحصن بين جبال سييرا نيفادا، مما جعلها صعبة المنال أمام الجيوش الغازية.
صمود مملكة غرناطة أمام الممالك المسيحية
ظلت مملكة غرناطة صامدة طوال قرنين ونصف، رغم الحصار المسيحي المستمر، وذلك بفضل استراتيجية متعددة الأبعاد جمعت بين الذكاء السياسي والقوة العسكرية والازدهار الاقتصادي. واعتمد بنو نصر حكام غرناطة على سياسة خارجية مرنة تقوم على مبدأ “الخضوع الشكلي والمقاومة العملية”، حيث كانوا يدفعون الجزية للممالك المسيحية عندما يضطرون، ويستغلون فترات الهدنة لتعزيز دفاعاتهم وتوطيد حكمهم.
من الناحية العسكرية، استفادت غرناطة من موقعها الجغرافي الفريد المحصن بالجبال، حيث بنى حكامها سلسلة من القلاع والحصون على مرتفعات سييرا نيفادا، تحولت إلى خط دفاعي متكامل. كما طوروا نظامًا متقدمًا للإنذار المبكر باستخدام المشاعل والدخان، مما مكنهم من رصد تحركات الجيوش المعادية من مسافات بعيدة. ولم يقتصر دفاعهم على الوسائل التقليدية، بل ابتكروا أساليب حرب عصابات فعالة اعتمدت على الكمائن والمناورات السريعة في الأودية والجبال.
اقتصاديًا، حول بنو نصر مملكتهم إلى قوة تجارية كبرى، فاستثمروا في الزراعة المروية المتطورة. وأنشأوا شبكة من السواقي والقنوات التي حولت السفوح الجبلية إلى بساتين خضراء. كما ازدهرت لديهم الصناعات الحرفية كالنسيج والخزف وصناعة الأسلحة، والتي كانت تصدر إلى الممالك المسيحية نفسها. هذا الازدهار المالي مكنهم من دفع الجزية عند الضرورة، مع الحفاظ على خزينة ممتلئة لتجهيز الجيوش.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أتقن حكام غرناطة فن “توازن القوى”، حيث تحالفوا تارة مع قشتالة ضد أراغون، وتارة أخرى مع أراغون ضد قشتالة، مستغلين تنافس الممالك المسيحية فيما بينها. كما استعانوا بعلاقاتهم الوثيقة مع المغرب، حيث كانوا يستقدمون المقاتلين والمؤن في الأوقات الحرجة. وفي الوقت نفسه، حافظوا على هوية إسلامية واضحة، فشجعوا العلم والعلماء، وجعلوا من غرناطة مركزًا للإشعاع الثقافي يجذب المفكرين من العالم الإسلامي.
اتحاد مملكتي أراغون وقشتالة
شكل عام 1469م منعطفًا حاسمًا في تاريخ الأندلس، فقد تزوجت إيزابيلا الأولى ملكة قشتالة من فرديناند الثاني ملك أراغون. وبهذا الزواج جمعت المملكتين المسيحيتين الرئيسيتين في شبه الجزيرة قوتهما. لم يكن هذا الاتحاد مجرد رباط زوجي، بل كان اندماجًا استراتيجيًا وضع أسس ما سيصبح لاحقًا إسبانيا الموحدة. وحمل هذا التحالف في طياته إنذارًا بالخطر للوجود الإسلامي المتبقي في الجنوب، حيث أخذت الممالك المتحدة على عاتقها مهمة “استكمال الاسترداد”.
وسبق هذا الزواج الملكي قرون من التطورات السياسية والعسكرية. فقد كانت قشتالة، بمساحتها الشاسعة ومواردها البشرية الكبيرة، تمثل القوة العسكرية الرئيسية. بينما جاءت أراغون بأسطولها البحري القوي وخبرتها الدبلوماسية الواسعة. وكان اتحاد هاتين القوتين يعني ظهور كيان سياسي وعسكري لا قِبَل للممالك الإسلامية الصغيرة به، خاصة في ظل التشرذم الذي أصابها بعد سقوط دولة الموحدين.
تبنى فرديناند وإيزابيلا سياسة منهجية للقضاء على الوجود الإسلامي. وبدأت هذه السياسة بحصار مالقة عام 1487م، التي سقطت بعد معاناة شديدة، تلاها استسلام العديد من المدن الأندلسية تباعًا. واعتمد الحكام الجدد على استراتيجية عسكرية محكمة، جمعت بين الحصار الطويل والهجمات المباشرة، مع الاستفادة من أحدث تقنيات المدفعية في ذلك الوقت.
سقوط غرناطة
بعد اتحاد مملكتي قشتالة وأراغون بزواج إيزابيلا وفرديناند، أصبح مصير غرناطة محتومًا. حيث كانت المدينة الأخيرة الباقية من ممالك الطوائف الإسلامية التي حكمت الأندلس. وقد بدأت ملامح النهاية تلوح في الأفق منذ منتصف القرن الخامس عشر. حيث قام الملكان الكاثوليك بتطبيق استراتيجية محكمة تمثلت في:
عزل غرناطة عن أي مساعدات خارجية من المغرب.
السيطرة التدريجية على القرى والبلدات المحيطة.
بناء قواعد عسكرية دائمة حول المدينة.
استخدام المدفعية الحديثة التي جلبها خبراء أوروبيون.
وقد بدأ الحصار الفعلي لغرناطة عام 1482م واستمر حتى 1492م. وخلال هذه السنوات العشر، عانى سكان المدينة من شح المواد الغذائية بعد قطع طرق الإمداد. وتحولت الحقول الخصبة خارج الأسوار إلى ساحات قتال، مما أفقد المدينة مصدرها الرئيسي للغذاء. وقام الجيش القشتالي بتطويق المدينة بشكل كامل، مع تركيز الهجمات على نقاط الضعف في الأسوار. كما استخدم المدفعية الثقيلة لقصف التحصينات بشكل يومي.
وقد ساهمت الانقسامات داخل الأسرة الحاكمة في تسريع السقوط. حيث تنازع أبناء أبو الحسن علي، آخر السلاطين الأقوياء، على الحكم. فقام أبو عبد الله محمد الصغير (المعروف ببو عبديل) بخلع والده بمساعدة القشتاليين، مما أضعف المقاومة. وتحولت القصور الملكية إلى ساحات للدسائس والمؤامرات، بينما كانت جيوش العدو تقترب أكثر فأكثر.
وفي 25 نوفمبر 1491م، وقع أبو عبد الله الصغير آخر ملوك الأندلس معاهدة تسليم المدينة. ونصت الاتفاقية على:
تسليم المدينة خلال شهرين.
ضمان حرية الدين للمسلمين.
احترام ممتلكات السكان.
السماح لمن يرغب بالهجرة إلى شمال إفريقيا.
وفي 2 يناير 1492م، دخلت القوات المسيحية غرناطة رسميًا، ورُفع الصليب فوق قصر الحمراء.
وضع المسلمين بعد سقوط مملكة غرناطة
مع تسليم مفاتيح غرناطة، دخل المسلمون في الأندلس مرحلة جديدة من المعاناة. كانت بنود الاستسلام التي وقعها أبو عبد الله الصغير مع الملكين الكاثوليك تمنح المسلمين حقوقًا تبدو كريمة على الورق، لكن الواقع سرعان ما كشف عن سياسة منهجية للقضاء على الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية.
التنصر القسري
واجه المسلمون خيارين صعبين بعد السقوط: إما اعتناق المسيحية أو المغادرة. وبدأت محاكم التفتيش بقيادة الطائفة الدومينيكانية حملة منظمة لإجبار المسلمين على التنصر. وتم تعميد آلاف المسلمين في مراسم جماعية، بينما أحرقت المصاحف والكتب الإسلامية في الساحات العامة. وتحولت المساجد إلى كنائس، ومنعت ممارسة الشعائر الإسلامية علنًا. وعرف هؤلاء المتنصرون قسرًا باسم “الموريسكيين”، وظلوا تحت مراقبة محاكم التفتيش لعدة أجيال.
الهجرة
اختار العديد من المسلمين مغادرة الأندلس رغم الصعوبات الجمة. وتوجه معظمهم إلى شمال إفريقيا، خاصة المغرب والجزائر وتونس. لم تكن الهجرة سهلة، حيث تعرض الكثيرون للسلب والنهب أثناء رحلتهم. ومن تمكن من الوصول إلى الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، حمل معه تراثًا ثقافيًا أندلسيًا غنيًا ساهم في إثراء الحضارة المغاربية. وأسس بعض المهاجرين أحياء كاملة عرفت باسم “أحياء الأندلسيين” في مدن مثل فاس وتلمسان وتونس.
ثورات الموريسكيين
الذين ظلوا تحت الحكم الجديد، عاشوا في ظل نظام تمييزي:
أجبروا على تغيير أسمائهم وأزيائهم.
منعوا من التحدث بالعربية علنًا.
خضعوا لرقابة دائمة من محاكم التفتيش.
حرموا من العديد من المهن والحرف التقليدية.
أجبروا على تبني العادات المسيحية في حياتهم اليومية.
لم يستسلم الجميع لهذا الواقع الجديد. واندلعت عدة ثورات أهمها:
ثورة البشرات (1500-1501م) بقيادة ابن أمية، التي قمعت بوحشية. ثم ثورة غرناطة الكبرى (1568-1571م) التي استمرت ثلاث سنوات قبل أن يتم إخمادها ونفي جميع الموريسكيين من منطقة غرناطة إلى مناطق أخرى من إسبانيا.
وبلغت المأساة ذروتها مع مرسوم الطرد العام عام 1609م، عندما أمر الملك فيليب الثالث بطرد جميع الموريسكيين من إسبانيا. حيث تم ترحيل مئات الآلاف قسرًا، مما أنهى الوجود الإسلامي الرسمي في شبه الجزيرة الأيبيرية بعد ثمانية قرون من الوجود.
مساعدة الدولة العثمانية لمسلمي الأندلس بعد سقوط مملكة غرناطة
بعد سقوط غرناطة، قدمت الدولة العثمانية تحت قيادة السلاطين بايزيد الثاني وسليم الأول وسليمان القانوني أشكالاً متعددة من الدعم لمسلمي الأندلس. وتمثلت هذه المساعدات في تنظيم عمليات إجلاء آلاف المسلمين عبر الأسطول العثماني من الموانئ الأندلسية إلى شمال إفريقيا والأناضول، حيث استقر العديد منهم في مدن مثل إسطنبول وسلا وطرابلس. كما ضغط السلاطين العثمانيون دبلوماسيًا على الممالك الأوروبية من خلال معاهدات تضمنت بنودًا لحماية حقوق الموريسكيين، وأرسلوا سفنًا حربية لشن غارات انتقامية على السواحل الإسبانية ردًا على اضطهاد المسلمين.
واصل العثمانيون دعمهم للمسلمين الأندلسيين حتى القرن السابع عشر. حيث خصص السلطان مراد الثالث أحياء كاملة في سالونيك وإسطنبول للاجئين الأندلسيين، ووظف العديد منهم في البلاط العثماني كمستشارين وخبراء في العلوم العسكرية. كما شجع العثمانيون نقل التراث الأندلسي العلمي والثقافي إلى أراضيهم، حيث تمت ترجمة مئات المخطوطات الأندلسية إلى التركية.
اقرأ أيضًا: عمار بن ياسر رضي الله عنه
المصادر:
المقري: نفح الطيب
ليفي بروفنسال: تاريخ المسلمين في إسبانيا.
وثائق الأرشيف الوطني الإسباني: معاهدة تسليم غرناطة.
دراسات جامعة غرناطة عن النقوش الأثرية في الحمراء.
ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر.
محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس.
حسين مؤنس: غرناطة في ظل بني نصر.
وثائق محاكم التفتيش الإسبانية (أرشيف إشبيلية).
الدراسات الأثرية الحديثة في قصر الحمراء.
الأرشيف العثماني في إسطنبول (وثائق ديوان همايون).
































































































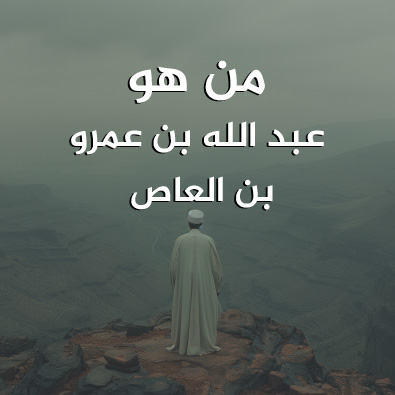




























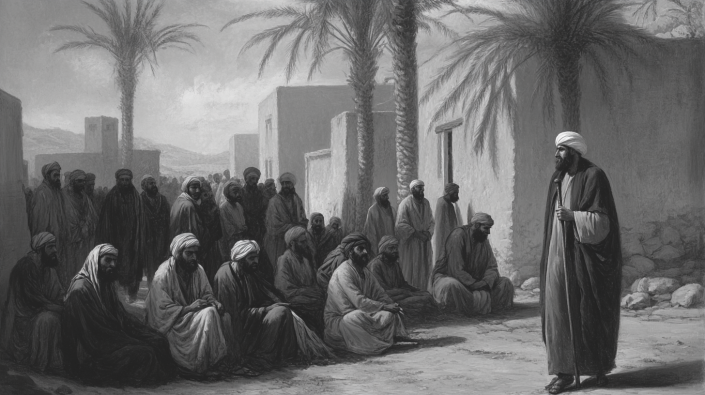













































































































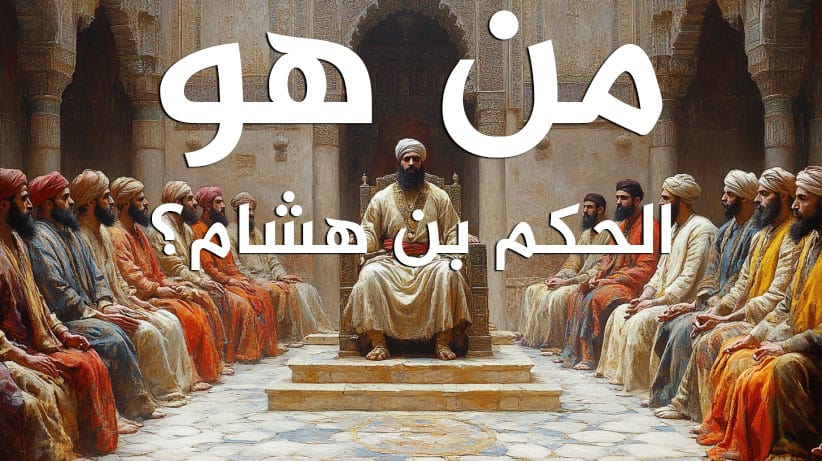






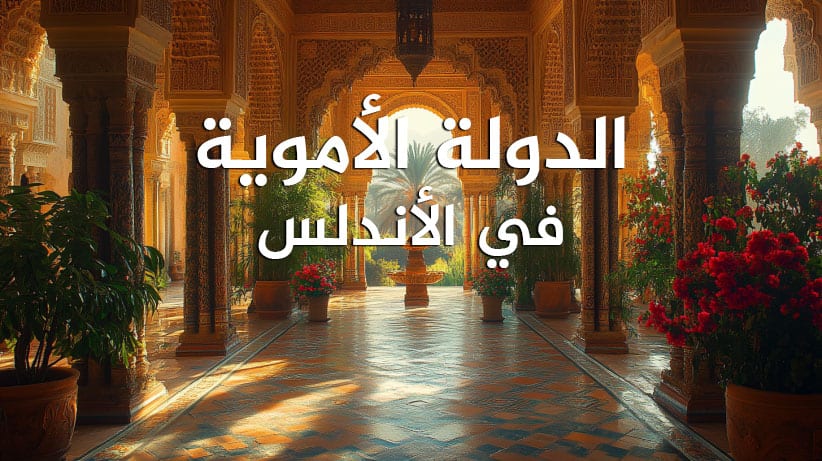

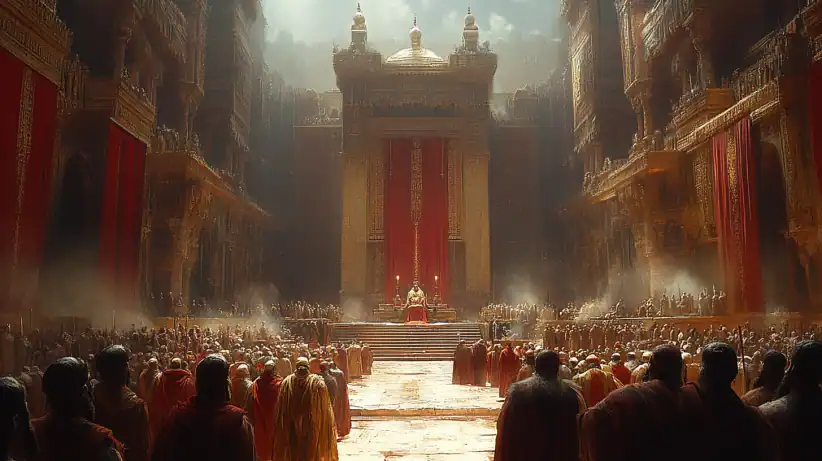

التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
اترك تعليق